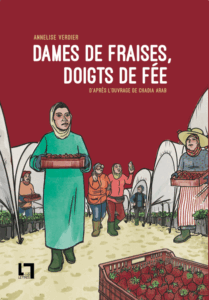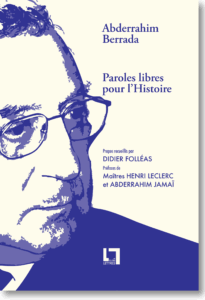بداية الحكاية: “حين رحلت أمي”
اسمي يامنة، من دوار صغير في نواحي دكالة. لا أذكر من طفولتي سوى وجه أمي المضيء حين كانت تسرّح شعري قرب الموقد، ورائحة الخبز الساخن في الصباح. كنت أعتقد يومها أن العالم بسيط ودافئ مثل حضنها. لكن ذات صباح، اختفى ذلك الدفء إلى الأبد. رحلت أمي بعد مرض قصير، وتركت وراءها طفلة لم تتجاوز الثامنة…
بعد أشهر قليلة، تغيّر كل شيء. تزوّج أبي من امرأة غريبة لم تعرف يوماً معنى الحنان، وصرتُ عبئاً على بيتٍ لم يعد بيتي. كنت أسمع همسات الجيران: “سير بها للمدينة، تخدم عند شي عائلة”. وفعلاً، لم يطل الوقت حتى أخذني أبي بيديه وسلّمني لعائلة في الدار البيضاء، كمن يسلّم شيئاً لا يريد الاحتفاظ به. قال لي: “كوني مؤدّبة، ما تقلقيش الناس”. ولم أكن أدري أنني أُسلَّم لمصير قاسٍ سيغتال ما تبقّى من طفولتي.
في البيت الجديد، لم تكن هناك ألعاب ولا دفاتر. كنت أستيقظ قبل الجميع، أنظّف الأرض، أغسل الأواني، أرتّب الأسرة، وأخاف من أن يسقط كأس زجاجي من يدي. لأن أي خطأ، ولو بسيط، كان يعني الضرب والكي والإهانة. أتذكر جيداً صوت صراخ السيدة حين انكسر كوبٌ ذات يوم، وكيف جرّتني من شعري وأحرقت يدي بملعقة ساخنة. كان الألم لا يُحتمل، لكنّ الخوف كان أكبر.
لم يكن أحد يسأل عني. أبي نسي أن له ابنة. وزوجته الجديدة كانت تقول له إنني بخير في المدينة. وكنت أصدّق أني ربما خلقت لأكون خادمة مدى الحياة. في المساء، كنت أسمع ضحكات الأطفال من نافذة المطبخ، وهم عائدون من المدرسة، أحمل الدلو بيدي، وأتساءل: لماذا لستُ مثلهم؟ لماذا لا أحمل حقيبة بل إسفنجة ومكنسة؟
مرّت السنوات بطيئة وثقيلة داخل جدران البيت الذي خُيّل إليّ أنه لن يفتح بابه لي أبداً. كنت أعمل من الفجر حتى الليل، أسمع كلمات جارحة تقتلع ما تبقّى من ثقتي بنفسي. كنت أخاف من كل شيء، حتى من صوت خطواتهم.
لم يعد أبي يسأل عني، بل سمعت لاحقًا أنه تزوج بعد أن سلّمني للعمل، وكأنني صفحة طويت من حياته. كنت أتساءل أحيانًا إن كان ما زال يتذكر ملامحي أو اسمي، لكن الجواب كان يأتي قاسياً من داخلي: “لا”.
كنت أكبر بصمت، لكن قلبي يضجّ بالأسئلة والخوف. في المراهقة بدأت أشعر بالاختناق، بشوقٍ غامض للحرية، وبحلمٍ صغير أن أعيش مثل باقي البنات. وفي ليلةٍ لم أنسها، قررت الهروب.
خرجت بخطوات مرتجفة من باب المطبخ، أحمل حقيبة صغيرة فيها قطعة خبز وثوب واحد. لم أكن أعرف إلى أين أذهب، فقط أردت أن أهرب من الألم. سرت في الشارع وحيدة، حتى سقطت على الرصيف من التعب والخوف.
لم يطل الوقت حتى التقطتني امرأة عجوز تعمل في السوق، أخذتني إلى منزلها الصغير. ظننت للحظة أني نجوت، لكن المدينة لم تكن رحيمة. لم تمضِ أشهر حتى عثر عليّ أحد معارف العائلة التي كنت أعمل عندها، وأعادوني إليهم. نلت عقاباً قاسياً، وجُرّدت من أي أملٍ في الخلاص.
بعد تلك الليلة، لم أعد أحلم. كنت فقط أعيش.
حين بلغت السادسة عشرة، قرروا أن “يستروا عليّ”. لم يسألني أحد عن رأيي. قالوا إن رجلاً من الحي يريد الزواج بي. لم أكن أفهم معنى الزواج سوى أنه مخرج من بيت العذاب.
تزوجت وأنا لا أملك شيئاً غير خوفٍ متراكم. زوجي لم يكن أفضل حالاً؛ كان يرى فيّ مجرد خادمة أخرى، صامتة لا تجرؤ على الاعتراض.
استمرت المعاناة بأشكال مختلفة: العنف، الإهانة، والحرمان من التعليم والحياة. أنجبت أطفلتي الاولى ، لكن الخوف لم يفارقني. كنت أرى في وجهها طفولتي المسروقة، وأخاف أن تعيش ما عشته.
اليوم، وأنا أحكي حكايتي، لا أبحث عن شفقة، بل عن فهم. أريد أن تُسمع قصص الفتيات اللواتي يُنتَزعن من طفولتهن قبل الأوان. أريد أن أقول: لا أحد يُولد ليُهان، ولا طفلة تُخلق لتكون خادمة.
كنت أظن أن الزواج سيكون بوابة الخلاص. كنت أقول في نفسي: “ربما هذا الرجل يعوضني عن طفولتي الضائعة، عن الضرب، عن الإهانة”. لكنّي كنت مخطئة.
منذ الأيام الأولى، اكتشفت أنني لم أغادر دائرة العنف، بل فقط تغيّر وجه من يمارسه.
كنت أعيش مع زوجي في بيت صغير تقطن فيه أيضًا أمه، امرأة شديدة القسوة، لا ترى فيّ إلا خادمة جاءت لخدمة ابنها. كانت تتحكم في كل تفاصيل حياتي، تراقب أكلي، ملبسي، كلامي، وحتى طريقة نظري.
إذا تأخرت في إعداد الطعام، تصرخ في وجهي أمام الجميع، وإن أجبتها بكلمة، تهددني قائلة:
“غادي نطردك، وولدي يطلقك، وتهزّي غير حوايجك وتمشي بحالك”.
كنت أخاف من كلمة “طلاق”، لأنني لا أعرف إلى أين أعود. لا بيت، لا أم، لا سند.
كان زوجي، الذي ظننته ملجئي، يصدق كل ما تقوله أمه. كان يرفع صوته عليّ، وأحيانًا يرفع يده.
وهكذا وجدت نفسي من جديد خادمة، ولكن هذه المرة في بيت أُفترض أنه “بيتي”.مرّت السنوات وأنا أتنقل بين الحمل والرضاعة والعمل المنزلي. أنجبت ستة أطفال، كل واحد منهم جاء وأنا غير مستعدة له، جسديًا ولا نفسيًا. لم أكن أعرف شيئًا عن تنظيم الأسرة، ولا عن حقوقي كزوجة، ولا عن كيفية العناية بجسدي.
كنت أتعلم كل شيء وحدي، بخوفٍ وصمت. لم تكن لدي أم تنصحني، ولا أخت أشتكي لها، ولا صديقة أثق بها.
كنت أرى النساء يتحدثن في السوق عن أشياء لا أفهمها، عن “حبوب” و”طبيب نساء”، فأعود إلى البيت متسائلة: هل أنا أقل من أن أعرف كيف أعتني بنفسي؟
“الهروب من دائرة الألم”
كبر أطفالي وأنا أتآكل من الداخل. لم أعد أحتمل العيش في بيت يُعاملني فيه الجميع كأنني لا شيء.
في يوم من الأيام، بعد شجار حاد مع أم زوجي، دفعني زوجي أرضًا أمام أبنائي، وصرخ في وجهي بكلماتٍ لن أنساها:
“لولا ولادي، رميتك للزنقة !”
في تلك الليلة، جلست قرب ابنتي الكبرى وهي نائمة، وقررت أن الأمر انتهى.
لم أكن أعرف إلى أين سأذهب، لكني كنت متأكدة أن البقاء يعني موتي ببطء.
جمعت بعض الثياب في كيس بلاستيكي، وانتظرت أن ينام الجميع، ثم خرجت من البيت كما خرجت يومًا من بيت تلك العائلة في الدار البيضاء…
لكن هذه المرة كنت أمًّا، لا طفلة.
مشيت طويلًا في الشارع حتى وصلت إلى محطة الحافلات، وهناك جلست أتنفس للمرة الأولى. كنت خائفة، لكن بداخلي شعور جديد… شيء يشبه الحرية.
لاحقًا، وبمساعدة إحدى الجمعيات النسائية، بدأت أعيد ترتيب حياتي، شيئًا فشيئًا. تعلمت ما معنى أن يكون لجسدك حق، أن تقولي “لا”، أن تطلبي المساعدة دون خوف، فهذا حق اساسي لكل النساء لكوني امراة لست مرادفا للضعف و القصور هذا القصور الذي يراني به الاخرون من مقربين و غرباء عنا الا قلة من الناس .
فيما بعد بدات اشتغل على مشروعي و استثمرت مهاراتي في الطبخ لاحصل على مدخول قار يسد حاجاتي تعرفت على نساء مثلي لدى استفادتي من تكوين و نساء فاعلات في مجالات كثيرة مختلفة مددن لي يد العون و
واليوم، حين أنظر إلى الماضي، لا أرى فقط الألم، بل أرى امرأة نهضت رغم كل شيء.
امرأة فقدت الأم، والطفولة، والاحتضان، لكنها استرجعت كرامتها ببطء، مثل زهرة تنبت بين الصخور.
قصتي ليست استثناءً، بل هي صوت آلاف النساء اللواتي لا يُسمع صوتهن.
وأنا أروي حكايتي لأقول:
“العنف لا يُبرّر، والصمت لا يحمي.
كل امرأة تستحق حياة آمنة، حرّة، وكريمة.”
مرية طاهر
 |
مرية طاهر ضو فيدرالية رابطة حقوق النساء مكتب جهة الرباط_سلا القنيطرة ومسؤولة عن مشروع أجيال للمساواة مكفة بالاستماع وتتبع ملفات الناجيات وضحايا العنف المبني على النوع من سنة 2024. |
| Ce texte a été réalisé dans le cadre de la session Storytelling pour l’égalité entre femmes et hommes, avec le soutien de l’Institut français du Maroc. À lire aussi sur Enass.ma. |  |